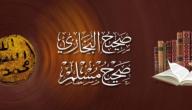محتويات
السلسلة الذهبية في علم الحديث
مصطلح السلسلة الذهبية في علم الحديث النبوي الشريف يُطلق على سند الحديث إذا كان جميع الرواة ثقات متقنين[١]، فإن روى الحديث النبوي الشريف راوٍ ثقة عن راوٍ ثقة عن راوٍ ثقة حتى يصل السند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أُطلق على سلسلة الرواة مصطلح السلسلة الذهبية، ومن نماذج البحث العلمي المميز والدقيق؛ المنهج العلمي الذي اتبعه علماء الحديث في علم الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف في قبول الرواية، فاعتمد علماء الحديث قواعدَ دقيقةً تقوم على الأمانة العلمية والنزاهة والدقة في النقل، وعدم اتباع الهوى، والسلامة من العلل، وقسم العلماء الرواة لثلاثة؛ أولهم: رواة اتفق جمهور علماء الحديث البارعون في هذا العلم وفرسانه المتمكنون فيه بأنهم رواة ثقات تقبل رواياتهم لما ثبت من إتقانهم وتقواهم، ولا يلتفت إلى الجرح اليسير عندهم الذي لا يضر في ضبطهم وإتقانهم، وثانيهم: رواة اتفق جمهور علماء الحديث إلى ضعفهم، فلا يؤخذ من وراياتهم، ولا ينظر إلى القليل والنادر مما صح عنهم بل يترك، وثالثهم: رواة اختلف فيهم علماء الحديث، فبعض العلماء تشددوا في اعتماد روياتهم، وآخرون تساهلوا في اعتمادها كل حسب قواعد وقرائن معينة[٢].
أشهر أحاديث السلسلة الذهبية
يشهد العلماء أن سلسلة الرواة المتصلة من الإمام الشافعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سلسلة ذهبية اتصل فيها الرواة الثقات من أول السند إلى منتهاه، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك قول الإمام أبي منصور التميمي: إن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد أورد ابن حجر تسعةً وتسعين حديثًا لهذه السلسلة الذهبية منها ما يأتي:
- قال الشافعي أنبأنا مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ) [صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر: (لا يجب في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول) [شرح مسند الشافعي| خلاصة حكم المحدث: صحيح][٣].
الفرق بين الحديث والسنة
يرى العلماء أن الفرق في المصطلحات عادةً ما يكون اختلافًا في اللفظ، أما الفرق بين الحديث والسنة، فيرى العلماء أنهما يجتمعان في بعض المعاني ويفترقان عند معانٍ أخرى، ومن مواضع الاجتماع مثلًا: يُطلق على تعريف (الحديث) وتعريف (السنة) بأنه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا تعريف علماء الأصول، وعند علماء الحديث زيادة، ومثال آخر: إذا ذكرت الفرقة الناجية، يطلق عليهم إما اسم (أهل الحديث) أو يقال إيضًا (أهل السنة)، وكذلك إذا ذكرت الكتب الخاصة بنقل المرفوع والموقوف من الآثار ومن أقوال السلف الصالح سميت هذه الكتب (كتب الحديث) أو تسمى أيضًا (كتب السنة).
فرَّق العلماء بين المصطلحين (الحديث والسنة) في مواضع منها: إذا أراد العلماء معنى طريقة ومنهج وصراط وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أو المجمل في جميع شؤون حياته عليه الصلاة السلام يُطلق مصطلح (السنة) غالبًا ولا يستخدم مصطلح الحديث، فالسنة ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم واقتدى به أصحابه ثم التابعون دون اشتراط تواتر الرواية اللفظية، وإنما كان التواتر فعلًا منقولًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته المعمول بها ولا يجوز مخالفتها، ومن أوجه الخلاف بين المصطلحين، أن العلماء أطلقوا على الالتزام بما ورد في الشريعة وعدم الابتداع والزيادة على ما جاء بالشرع مصطلح (السنة) وليس (الحديث)، فقيل سفيان الثوري إمام في الحديث، والأوزعي إمام في السنة، ومالك ابن أنس إمام في السنة والحديث، وفي بيان أو وصف حكم استحباب عمل أو فعل يستخدم العلماء مصطلح (سنة) ولا يستعملون مصطلح (حديث)، ويستخدم العلماء مصطلح (حديث) عند وصف الرواية بالتصحيح أو التضعيف أو التحسين وغيرها، فيقولون حديث حسن أو حديث صحيح أو حديث ضعيف ولا يقولون سنة صحيحة أو سنة ضعيفة، فلا يستخدمون في هذا المقام مصطلح (السنة) أبدًا[٤].
أنواع الحديث النبوي من حيث الثبوت
تنقسم الأحاديث النبوية الشريفة من حيث ثبوتها لثلاثة أقسام: المتواتر والمشهور والآحاد، وفيما يأتي لمحة مختصرة عن كل منها[٥]:
- الأحاديث المتواترة: هي الاحاديث التي رواها جمع عن جمع يستحيل اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب، ويكون ذلك من أول طبقة في السند إلى آخر طبقة، وهو نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي:
- المتواتر الفظي: هو الحديث الذي تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصيغة والألفاظ وبنفس المعنى، فالحديث النبوي الشريف (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) [تخريج المسند|خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح]رواه بهذا اللفظ وهذا المعنى أكثر من 70 صحابيًا.
- المتواتر بالمعنى: فهو الحديث الذي نقل متفق على معناه لكن لم تتطابق الرويات في اللفظ، مثال: أحاديث الشفاعة، وأحاديث نبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام.
- الأحاديث المشهورة: هي الأحاديث التي لم تبلغ حد التواتر في النقل وإنما رواها في كل طبقة ثلاثة أو أكثر دون حد التواتر.
- الأحاديث الآحاد: هي الأحاديث التي لم تتوفر فيها شروط المتواتر أو المشهور، ونقلها في كل طبقة واحد أو اثنان.
ومن العلماء من قسم أنواع الحديث لقسمين: متواتر وآحاد وجعل المشهور جزءًا من الآحاد.
أنواع الحديث الشريف من حيث النسب
يقسم العلماء الحديث حسب قائله، فقد يُنسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يُنسب لغيره[٦]، وفيما يأتي أنواع الحديث الشريف من حيث النسب:
- الحديث المرفوع: هو الحديث الذي أُضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء أكان قولًا أم فعلًا أم تقريرًا أم صفةً خلقيةً أو خُلقيةً.
- الحديث الموقوف: هو ما أُضيف إلى الصحابي وليس إلى النبي صلى الله علية وسلم، فهو كلام الصحابي أو فعله.
- الحديث المقطوع: هو الأثر الذي أُضيف إلى التابعي من قول أو فعل.
أشهر كتب الحديث
اهتم العلماء بالحديث عنايةً فائقةً، كونه مصدر التشريع الثاني، وصنفوا كتب الأحاديث على أشكال مختلفة، ومن أشهر هذه التصنيفات ما يأتي[٧]:
- الجوامع: مثال (الجامع الصحيح للإمام البخاري)، يجمع فيه المؤلف جميع الأبواب فيتكون في الجامع من باب العقائد وباب العبادات وباب المعاملات وباب السير وباب المناقب وباب الرقائق وباب الفتن وباب أخباريوم القيامة.
- المسانيد: مثال (مسند الإمام أحمد بن حنبل) وفيه يجمع المؤلف مرويات كل صحابي في باب واحد، ولا تُشترط وحدة الموضوع.
- السنن: مثال (سنن أبي داود)، ويصنف الكاتب فيه أبوب الفقه المختلفة، ولا يتحدث فيها عن العقائد أو السير أو المناقب، بل يقتصر على الفقه.
- المعاجم: مثال (المعجم الكبير للطبراني) يجمع فيه المؤلف الحديث حسب الترتيب الهجائي بأسماء الشيوخ.
- العلل: مثال (العلل للدارقطني) وفيه يكتب المؤلف الأحاديث المعلولة، ويُبين أسباب العلة.
- الأجزاء: مثال (جزء رفع اليدين في الصلاة للإمام البخاري، وهي كتب صغيرة تُجمع فيها روايات أحد الرواة.
- الأطراف: مثال (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي) يذكر فيه المؤلف طرف الحديث الذي يدل على بقيته، ويذكر أيضًا أسانيد المتن.
فالكتب الجوامع تشتمل على جميع مجالات الدين ومحاوره من العقيدة إلى أخبار يوم القيامة الوردة فقط في الأحاديث النبوية الشريفة، بينما تقتصر كتب السنن على مجال واحد وهو الفقه وما ورد عنه من الأحاديث النبوية الشريفة، وكتب المساند تجمع أحاديث كل صحابي في باب، وهى مرتبة بأسماء الصحابة ترتيبًا هيجائيًا، بينما تختلف كتب المصنفات بأنها تشمل أقوال الصحابة، وفتاوى التابعين وتابعي التابعين، إضافةً إلى الأحاديث النبوية في مجال الفقه فقط، ومرتبة حسب ابواب الفقه[٨].
المراجع
- ↑ "أحاديث السلسلة الذهبية"، islamhouse، اطّلع عليه بتاريخ 28-12-2019. بتصرّف.
- ↑ "منهج المحدثين في التصحيح والتضعيف"، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ 28-12-2019. بتصرّف.
- ↑ تأليف: ابن حجر العسقلاني، مراجعة: ناصر بن سعيد السيف، أحاديث السلسلة الذهبية ، الرياض السعودية : دار ابن خزيمة، صفحة صفحة 5 وصفحة 12 وصفحة 13. اطّلع عليه بتاريخ 23-1-2020. بتصرّف.
- ↑ "هل هناك فرق بين مصطلح الحديث والسنة؟"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 28-12-2019. بتصرّف.
- ↑ "أنواع الحديث الشريف من حيث الثبوت والقبول"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 28-12-2019. بتصرّف.
- ↑ "شرح مراتب الحديث"، الإسلام سؤال وجواب ، اطّلع عليه بتاريخ 31-12-2019. بتصرّف.
- ↑ "أنواع كتب الحديث"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 28-12-2019. بتصرّف.
- ↑ "تدوين السنة النبوية"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 31-122019. بتصرّف.