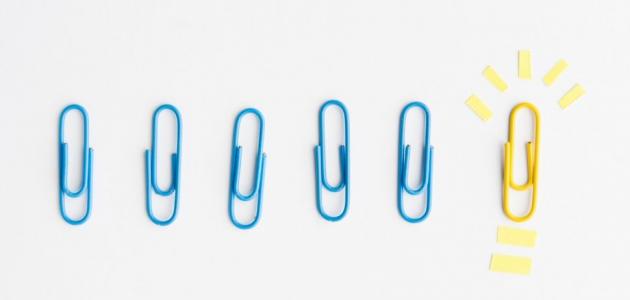محتويات
الحال والصفة
الحالُ صفةٌ نَكرة فضلةٌ مُشتَّقةٌ، تُذكر لوصف هيئةِ الفاعل، أو المفعول به، أو المجرورِ بحرف الجرِّ، ويكون هذا الوصف في فترة محدّدة ملازمة للحدث، مثل (قام أحمد خطيبًا) فكلمة (خطيبًا) هي حال يصف هيئة (أحمد) فترة قيامه فقط، وفي غير حدث القيام لا يكون خطيبًا، ويستدلُّ على الحال بسؤال يبدأ بـ (كيف؟) فتكون كلمة الحال هي الإجابة عليه في الجملة، مثل: (جئتُ مسرعًا)، فالحال: (مُسرعًا) جاء لبيان هيئة الفاعل، وفي جملة: (ركبتُ البحر هائجًا) الحال هو: (هائجًا)، جاء لبيان هيئة المفعول به، وفي جملة: (يبطشُ بالعدو فارًّا) الحال هو: (فارًّا) وجاء لبيان هيئة الجار والمجرور.
الأَصلُ في الحال الإفرادُ، ولكنها قد تأتي جملةً فعليةً، مثل: (جاء الولدُ يركض)، أو جملةً اسميّة مثل: (جاء الولدُ سَيرُه سريع)، ويسمّى الاسم الذي تُبيِّن الحالُ هيئته (صاحب الحال)، ويجب أنْ يكونَ معرفةً، لكن يمكن أن يأتي نكرة في مواضع منها[١][٢]:
- أن تتقدم الحال على صاحبها النكرة، مثل: (أقبل حافظًا طالبٌ) والأصل أن تكون كلمة (حافظ) صفة، لكنها انتصبت على الحال، لأنّه لا يجوز أن تتقدم الصفة على الموصوف.
- أن تكون النكرة مسبوقة بنفي، أو شبه النفي مثل قوله سبحانه: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ} [الحجر: 4] فجملة (ولها كتاب معلوم) حال صاحبها (قرية).
- أن تكون النكرة مسبوقة باستفهام مثل: (هل جاءك رجلٌ غاضبًا؟).
- أن تكون النكرة مسبوقة بنهي مثل: (لا يكتبُ أحدٌ درْسَه مستعجلًا).
- أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو، كقوله عز وجلّ: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} [البقرة:259].
- أن تكون جامدة مثل: (هذا خاتمٌ حديدًا) فكلمة (حديدًا) حال جامدة لكلمة (خاتم) وهي نكرة.
الصفة، اسمٌ تابع يُذكر لبيان صفة من صفات الاسم الذي قَبله، تتبعه وترتبط به، ويسميه بعض النحاة (النعت)، مثل: (هذا ولدٌ عاقل) فكلمة (عاقل) صفة لـ (ولد)، و(جاءت البنت المهذَّبة) فكلمة (المهذبة) صفة لـ (البنت)، وتتبع الصفة الموصوف في الرفع، والنصب، والجر، والإفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث، والتعريف، والتنكير، مثل: (هذا رجلٌ ضخم)، (التقيتُ بالمهندس البارعِ)، ( رأيتُ فتاتين جميلتين)، (ضاع لي كيس صغير أسود)، وتقسم الصفة أو (النعت) إلى نوعين: النعت الحقيقي، وهو: ما دلَّ على صفة مِن صفات الاسم الذي قبله مثل قوله سبحانه: { وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }[البقرة: 258]، فكلمة (الظالمين) نعت حقيقي؛ لأنها دلّت على صفة حقيقية من حيث اللفظ والمعنى من صِفاتِ المتبوع (القوم)، والنعت السببي وهو: ما دل على صفة من صفات اسم يأتي بعده، له ارتباط به، ويرفع اسمًا ظاهرًا متصلًا بضمير يعود إلى المنعوت، كقوله سبحانه: { رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا } [النساء: 75]، فـكلمة (الظالم) نعتٌ سببي، ولكنه ليس للاسم الذي سبقه (القرية)؛ إذ ليس الظلم هنا صفةً للقرية، بل صفة لما بعده (أهل القرية)، ولأنّ لأهل القرية ارتباطًا بها جاز القول اعتبار صفة أهل القرية صفةً للقرية، ولذلك يسمى نعتًا غير حقيقي، أو سببيًّا[٣][٤].
ما هو الفرق بين الحال والصفة؟
تختلف الحال عن الصفة بما يلي[٥][٤]:
- الصّفة تفرق بين اسمينِ مشتركين فِي اللّفظ، أما الحال فهي زيادة فِي الْفَائِدَة والخبر، فإذا أراد القائل مثلًا التفريق بين زيدِ وعبدالله، قال: (جاءني زيد الرَّاكِب) أَو (جاءني زيد القصير) أَو (العاقل)، وهي صفات، تصف من يعني القائل بكلامه ليفرق بينه وبين شخص آخر خاف أَن يلبس بِهِ، بمعنى جاء زيد المعروف بالركوب، أو المعروف بالقِصَر، ولكن في الإخبار عن الحال بمعنى الحال التي كان عليها زيد حين جاء، قال: (جَاءَنِي زيد رَاكِبًا أو ماشيًا).
- أما في الفرق بين الوصف والصفة تحديدًا فالصفة ثابتة للموصوف، وهي من الوصف، لكنها أخصّ، فالوصف اسم جنس يقع على كثيره وقليله، والصفة ضرب من الوصف مثل: الجلسة والمشية تصف هيئة الجالس والماشي، ولهذا أطلق على المعاني لفظ (صفات) مثل: (العفاف وَالْحيَاء من صِفَات الْمُؤمن) ولا يقال: (من أوصاف المؤمن) فالوصف لا يكون إلا قولًا، أما الصفة تكون بالهيئة، فالعلم والقدرة صفات، لأن الموصوف يعيها ويتصرف بها، أما الحال فهي وصفٌ غير ثابت لا يلازم هيئة الموصوف، بل يدل على هيئته المؤقتة.
- الصفة تتبع الموصوف في الحالة الإعرابية، وفي التثنية والإفراد والجمع، والتعريف والتنكير، ولا يتقيّد الحال بذلك.
كيف يمكن إعراب الحال والصفة؟
يمكن إعراب الحال والصفة، كما في النماذج التالية[١][٢][٤]:
- (جاء الطالب مُهرولًا)، مهرولًا: حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
- (جاء الطالب يهرولُ)، يهرولُ: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية: (يركض) في محل نصب حال.
- {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، قانتين: حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم.
- {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ} [آل عمران: 96]، مباركًا: حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
- {إنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً} [البقرة: 119]، بشيرًا: حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
- (هذاعليٌّ في المهماتِ أشجعَ من أخيه) أشجعَ: حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
- (أعجبني عليٌّ حمّالاً رايةَ المجدِ)، حمّالاً: حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
- {وهَـذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً} [الأنعام: 126]، مستقيمًا: حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
- (عليّ رجلٌ عاقلٌ)، عاقل: صفة مرفوعة لـ (تلميذ) وعلامة رفعها تنوين الضم الظاهر على آخرها.
- (أحب التلاميذ المهذبين)، المهذبين: صفة منصوبة لـ (التلاميذ) وعلامة نصبها الياء؛ لأنها جمع مذكر سالم.
- (هذان ولدان صادقان)، صادقان: صفة مرفوعة لـ (ولدان) وعلامة رفعها الألف؛ لأنها مثنى.
- (كتبت إلى الصديقِ الوفيِّ)، الوفي: صفة مجرورة لـ (الصديق) وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها.
من حياتكِ لكِ
من الأمثلة على الحال والصفة، ما يلي[٤][٣][٢]:
- {فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً} [مريم: 17].
- {وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً} [الأحقاف: 12].
- {وَلَّى مُدْبِراً} [القصص: 31].
- {وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً} [النساء: 28].
- {فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً} [النساء: 93].
- {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: 258].
- {ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ} [ق: 44].
- {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ } [الأحقاف: 35].
- {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} [النحل: 69].
- {وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا} [فاطر: 27].
- {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} [الدخان: 16].
- {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } [الأحزاب: 50].
- {وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ} [البقرة: 128].
- {ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ} [الزمر: 21].
- {فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا } [فاطر: 27].
- {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ } [عبس: 13].
- {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ} [الأنبياء: 2].
- {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى} [النساء: 36].
- سيف تلميذ ناجح.
- نهى فتاة طيبة.
- أحترم المعلمين المخلصين.
- هذان ولدان كبيران.
- سافرتُ إلى المدينة البعيدة.
المراجع
- ^ أ ب د. فهمي قطب الدين النجار (1/2/2015)، "الحال وإعرابه"، alukah، اطّلع عليه بتاريخ 9/6/2020. بتصرّف.
- ^ أ ب ت سعد حسن عليوي الزغيبي (15/10/2017)، "الحال"، uobabylon، اطّلع عليه بتاريخ 9/6/2020. بتصرّف.
- ^ أ ب أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن (2/9/2018)، "النعت السببي والحقيقي"، alukah، اطّلع عليه بتاريخ 9/6/2020. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث د. فهمي قطب الدين النجار (21/12/2014)، "من التوابع: النعت"، alukah، اطّلع عليه بتاريخ 9/6/2020. بتصرّف.
- ↑ [العسكري، أبو هلال]، "الْفرق بَين الصّفة وَالْحَال"، المكتبة الشاملة الحديثة، اطّلع عليه بتاريخ 9/6/2020. بتصرّف.